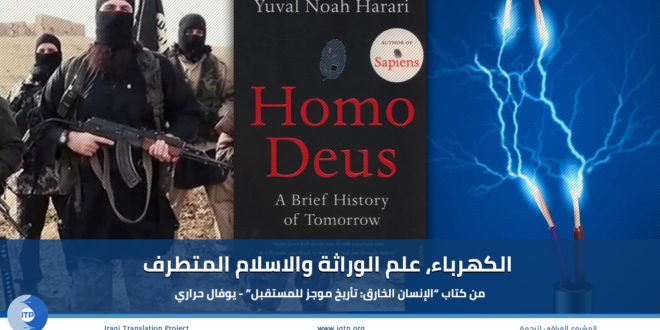ترجمة: أمنة الصوفي
المصدر: كتاب ”الإنسان الخارق: تأريخ موجز للمستقبل“ – يوفال حراري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعتبارا من عام 2016، لا يوجد بديل فعلي لمضامين الليبرالية كـ(الفردانية، حقوق الإنسان، الديمقراطية والسوق الحرة). إن الاحتجاجات الاجتماعية التي اجتاحت العالم الغربي في عام 2011 – مثل حركة احتلوا وول ستريت وحركة 15-م الإسبانية، لم يكن لديها على الاطلاق أي مقصد ضد الديمقراطية، الفردانية، حقوق الإنسان، أو حتى ضد المبادئ الأساسية لاقتصاد السوق الحر. بل على العكس تماماً، فهي تحاجج الحكومات بكونها لا ترقى إلى مستوى هذه المُثل الليبرالية. إنهم يطالبون بأن يكون السوق حراً حقاً، بدلاً من أن يتم التحكم فيه والتلاعب به من قبل الشركات والبنوك “الأكبر من أن تفشل”. إنهم يطالبون بمؤسسات ديمقراطية ذات طابع تمثيلي حقيقية، تخدم مصالح المواطنين العاديين، بدلا من مصالح جماعات الضغط الثرية وجماعات المصالح القوية. حتى أولئك الذين ينسفون الاسواق المالية والبرلمانات بأقسى الانتقادات ليس لديهم نموذج بديل قابل للتطبيق لإدارة العالم. في حين أن هواية الأكاديميين والناشطين الغربيين المفضلة هي العثور على أخطاء ضد المضامين الليبرالية، إلا أنهم فشلوا حتى الآن في التوصل إلى أي شيء أفضل منها.
يبدو أن الصين تخوض تحديًا أكثر خطورة من الاحتجاجات الاجتماعية في الغرب. على الرغم من تغيير سياساتها واقتصادها وجعله ليبرالياََ، إلا أن الصين ليست ديمقراطية ولا تضمن حرية السوق اقتصاديا، وهذا لا يمنعها من أن تصبح العملاق الاقتصادي للقرن الحادي والعشرين. لكن هذا العملاق الاقتصادي يلقي بشبح إيديولوجية صغيرة جداً. لا أحد يعرف ما الذي يؤمن به الصينيون هذه الأيام – بما في ذلك الصينيون أنفسهم. نظريا، لا تزال الصين شيوعية، ولكنها في الواقع ليست شيئًا من هذا القبيل. بعض المفكرون والقادة الصينيون يحاولون العودة إلى الكونفوشيوسية، لكنه لا يتعدى كونه مظهرا مخادعا. هذا الفراغ الأيديولوجي سيجعل الصين أكثر مناطق التناذر الواعدة للديانات التقنية الجديدة الناشئة من وادي السليكون. لكن هذه الديانات التقنية، مع إيمانها بالخلود والجنة الافتراضية، تحتاج على الأقل عقدًا أو عقدين من الزمن لتثبت جدارتها. لهذا السبب لا تشكل الصين في الوقت الحاضر بديلاً حقيقياً لليبرالية. إذا يأست اليونان المفلسة من النموذج الليبرالي وبدأت بالبحث عن بديل، فإن “تقليد الصينية” لن يقدم الكثير.
ماذا عن الإسلام المتطرف؟ أو المسيحية الأصولية واليهودية التبشيرية والإحيائية الهندوسية؟ في حين أن الصينيين لا يعرفون ما يؤمنون به، فإن الأصوليين الدينيين يعرفون ذلك جيداً. بعد أكثر من قرن من إعلان نيتشه موت الاله، يبدو أنه قد بُعث. لكن هذا مجرد سراب. لقد مات الاله – سيستغرق الأمر بعض الوقت للتخلص من الجثة. لا يشكل الإسلام المتطرف تهديدًا خطيرًا للمضامين الليبرالية، لأنه على الرغم من حماسة مناصريه، فإن المتعصبين لا يفهمون حقاً حقبة القرن الواحد والعشرين، ولا يمتلكون أدنى فكرة عن المخاطر والفرص الجديدة التي تولدها التقنيات الجديدة من حولنا.
الدين والتكنولوجيا دائماً يرقصون رقصة التانغو المرهفة. إنهم يدفعون بعضهم بعضا ويعتمدون على بعضهم البعض ولا يستطيعون الابتعاد عن بعضهم البعض. تعتمد التكنولوجيا على الدين، لأن كل اختراع له العديد من التطبيقات المحتملة، ويحتاج المهندسون إلى مبعوث ما لحسم الخَيار الحاسم والإشارة إلى الوجهة المطلوبة. نتيجة لكل ذلك، ابتكر المهندسون في القرن التاسع عشر القاطرات وأجهزة الراديو ومحركات الاحتراق الداخلي. ولكن كما أثبت القرن العشرين، يمكنك استخدام هذه الأدوات ذاتها لخلق مجتمعات فاشية وديكتاتوريات شيوعية وديمقراطيات ليبرالية. بدون بعض القناعات الدينية، لا تستطيع القاطرات تحديد المكان الذي ستذهب إليه.
من ناحية أخرى، غالباً ما تحدد التكنولوجيا نطاق وحدود رؤيتنا الدينية، مثل النادل الذي يحدد شهيتنا بتسليمنا قائمة طعام. تقتل التقنيات الجديدة الآلهة القديمة وتلد آلهة جديدة. هذا هو السبب في أن آلهة عصر الزراعة تختلف عن الالهة البدائية في عصر الصيادين-الجامعين، ولماذا من المرجح أن تؤدي التقنيات الثورية في القرن الحادي والعشرين إلى توليد حركات دينية لم يسبق لها مثيل أكثر من مجرد إحياء معتقدات القرون الوسطى. قد يكرر الأصوليون الإسلاميون اسطوانتهم بأن “الإسلام هو الحل”، لكن الأديان التي تفقد التواصل مع الواقع التكنولوجي المعاصر تفقد قدرتها حتى على فهم الأسئلة التي يتم طرحها. ماذا سيحدث لسوق العمل عندما يتفوق الذكاء الاصطناعي على البشر في معظم المهام المعرفية؟ ماذا سيكون التأثير السياسي لطبقة جديدة ضخمة من الناس عديمي الفائدة اقتصاديا؟ ماذا سيحدث للعلاقات والأسر وصناديق التقاعد عندما تحول النانوتكنولوجيا والطب الأصلاحي شخص ثمانيني الى خمسيني العمر؟ ماذا سيحدث للمجتمع البشري عندما تمكننا التكنولوجيا الحيوية من أن يكون لدينا أطفال مصممين، وفتح فجوات غير مسبوقة بين الأغنياء والفقراء؟
لن تجد الإجابة على أي من هذه الأسئلة في القرآن أو الشريعة، ولا في الكتاب المقدس أو في التقاليد الكونفوشيوسية، لأن لا أحد في الشرق الأوسط في القرون الوسطى أو في الصين القديمة يعرف الكثير عن الحواسيب أو علم الوراثة أو تكنولوجيا النانو. قد يتعهد الإسلام المتطرف ارساء مرساة الأمان في عالم من العواصف التكنولوجية والاقتصادية – ولكن من أجل اجتياز العاصفة، فإنك تحتاج إلى خريطة ودفة بدلاً من مجرد مرساة. ومن هنا قد يجذب الإسلام المتطرف الأشخاص الذين ولدوا وترعرعوا في محيطه المغلق، لكن لديه القليل ليقدمه للشباب الإسباني العاطل عن العمل أو المليارديرات الصينيين المنهمكين.
صحيح أن مئات الملايين قد يستمرون في الايمان بالإسلام أو المسيحية أو الهندوسية. لكن الأرقام وحدها لا تُعار الكثير من الأهمية في التاريخ. غالباً ما يتم صناعة التاريخ من قبل مجموعات صغيرة من المبدعين الذين يتطلعون إلى الأمام بدلاً من المجموعات الجماهيرية المتخلفة. قبل عشرة آلاف عام، كان معظم الناس من الصيادين – الجامعين ولم يكن سوى عدد قليل من الرواد في الشرق الأوسط من المزارعين. ومع ذلك، فإن المستقبل صنعه المزارعون. في عام 1850، كان أكثر من 90٪ من البشر من الفلاحين، وفي القرى الصغيرة الواقعة على طول نهر الجانج، النيل و اليانغتسي لم يعرف أحداََ أي شيء عن المحركات البخارية أو خطوط السكك الحديدية أو خطوط التلغراف. ومع ذلك، فإن نِتاج هؤلاء الفلاحين قد تمت مصادرته بالفعل في مانشستر وبرمنغهام من قبل حفنة من المهندسين والسياسيين والممولين الذين قادوا الثورة الصناعية. طورت المحركات البخارية والسكك الحديدية والتلغراف إنتاج الأغذية والمنسوجات والمركبات والأسلحة، مما منح القوى الصناعية ميزة أسمى من المجتمعات الزراعية التقليدية.
حتى عندما انتشرت الثورة الصناعية في جميع أنحاء العالم وتوغلت في نهر الغانج والنيل ونهر اليانغتسى، واصل معظم الناس ايمانهم في الفيدا، والكتاب المقدس، القرآن، وتعاليم كونفوشيوس أكثر من المحرك البخاري. كما هو الحال اليوم، كذلك في القرن التاسع عشر، لم يكن هناك نقص في الكهنة والصوفية والمعلمين الذين جادلوا بأنهم وحدهم يحملون الحل لجميع مشاكل البشرية، بما في ذلك المشاكل الجديدة التي خلقتها الثورة الصناعية. على سبيل المثال، بين 1820 و 1880 قامت مصر (بدعم من بريطانيا) بغزو السودان، وحاولت تحديث البلاد ودمجها في شبكة التجارة الدولية الجديدة. هذا المجتمع السوداني التقليدي غير المتزعزع، خَلقَ استياء واسع النطاق وعزّز من فرص قيام الثورات. في عام 1881، أعلن زعيم ديني محلي، محمد أحمد بن عبد الله، أنه المهدي (المخلص)، الذي أرسل لإرساء شريعة الله على الأرض. هزم أنصاره الجيش الأنجلو-مصري، وقطعوا رأس قائده – الجنرال تشارلز جوردون – في حادثة صدمت بريطانيا الفيكتورية. ثم أسسوا في السودان دولة دينية إسلامية تحكمها الشريعة، والتي استمرت حتى عام 1898.
في تلك الأثناء في الهند، ترأس داياناندا ساراسواتي حركة إحياء الهندوسية، كان مبدأها الأساسي هو أن الكتاب المقدس الفيدي لا يُخطئ أبداً. في عام 1875 أسس مجتمع أطلق عليه آريا ساماج (المجتمع النبيل)، المكرس لنشر التعاليم الفيدية – ولكن، والحق يُقال، فإن دياناندا غالباً ما فسر الفيدا بطريقة ليبرالية مدهشة، ودعم على سبيل المثال حقوق النساء في المساواة قبل أن تصبح الفكرة شائعة في الغرب بفترة طويلة.
كان لدى البابا بيوس التاسع الذي عاصر دياناندا وجهات نظر محافظة أكثر بكثير حول النساء، لكنه شارك دياناندا في الإعجاب بسلطة الإنسان العليا. قاد بيوس سلسلة من الإصلاحات في العقيدة الكاثوليكية، وأرسى المبدأ الجديد للعصمة البابوية، والذي يَفترض أن البابا لا يُخطئ في مسائل الإيمان (هذه الفكرة التي سادت في العصور الوسطى فيما يبدو أصبحت عقيدة كاثوليكية ملزمة فقط في عام 1870، بعد أحد عشر عاما من نشر تشارلز داروين كتابه أصل الأنواع).
قبل ثلاثين عاما من اكتشاف البابا أنه غير قادر على ارتكاب الأخطاء، كان هناك عالم صيني يدعى هونغ شيكيوان كان له سلسلة من الرؤى الدينية. في هذه الرؤى، صرّح الاله أن هونج لم يكن سوى الأخ الأصغر ليسوع المسيح. اذ أُرسل هونغ في مهمة إلهية. وأمر بطرد “شياطين مانشو” التي حكمت الصين منذ القرن السابع عشر، لينشئ على الأرض مملكة السماء السلمية العظمى (تايبينغ تيناجو). وأطلقت رسالة هونغ العنان لخيال ملايين الصينيين اليائسين الذين هزتهم هزائم الصين في حروب الأفيون وقدوم الصناعة الحديثة والإمبريالية الأوروبية. لكن هونغ لم يقودهم إلى مملكة السلام. بدلا من ذلك، قادهم الى حرب ضد سلالة مانشينغ تشينغ في تمرد سُمي بتمرد تايبينغ – الحرب الأكثر دموية في القرن التاسع عشر. من 1850 إلى 1864، فَقد خلالها ما لا يقل عن 20 مليون شخص حياتهم؛ أكثر بكثير مما فُقد في الحروب النابليونية أو في الحرب الأهلية الأمريكية.
تمسك مئات الملايين بالعقائد الدينية لهونغ، ودياناندا، وبيوس، ومحمد أحمد بن عبد الله (المهدي) حتى عندما كانت المصانع الصناعية والسكك الحديدية والبواخر تغزو العالم. مع ذلك، معظمنا لا يعتبر القرن التاسع عشر عصر الإيمان. عندما نفكر في أصحاب الرؤى في القرن التاسع عشر، من المرجح أن نستذكر ماركس وإنجلز ولينين أكثر من محمد أحمد بن عبد الله (المهدي)، بيوس التاسع أو هونغ تشيوان. ولنا الحق في ذلك. على الرغم من أن الاشتراكية في عام 1850 كانت مجرد حركة هامشية، إلا أنها سرعان ما اكتسبت زخما، وغيرت العالم بأساليب أعمق بكثير من المخلصين المزعومين في الصين والسودان. إذا كنت تعتمد على الخدمات الصحية الوطنية، وصناديق التقاعد والمدارس المجانية، فأنت بحاجة إلى شكر ماركس ولينين (وأوتو فون بسمارك) أكثر بكثير من هونغ تشيوان أو محمد أحمد (المهدي).
لماذا نجح ماركس ولينين فيما فشل كل من هونغ والمهدي؟ ليس لأن الانسانية الاشتراكية كانت فلسفة أكثر تطوراً من اللاهوت الإسلامي والمسيحي، ولكن لأن ماركس ولينين كرسوا المزيد من الاهتمام لفهم الحقائق التكنولوجية والاقتصادية لعصرهم أكثر من الاهتمام في النصوص القديمة والرؤى النبوية. خلقت المحركات البخارية والسكك الحديدية والتلغراف والكهرباء مشاكل لم يُسمع بها من قبل بالإضافة إلى فرص غير مسبوقة. كانت تجارب الطبقة الجديدة من البروليتاريا الحضرية واحتياجاتها وآمالها مختلفة ببساطة عن تلك الخاصة بالفلاحين التوراتيين. وللإستجابة لهذه الاحتياجات والآمال، درس ماركس ولينين كيف يعمل المحرك البخاري، وكيف يعمل منجم الفحم، وكيف تشكل خطوط السكك الحديدية الاقتصاد وكيف تؤثر الكهرباء على السياسة.
طُلب من لينين في الماضي تعريف الشيوعية في جملة واحدة. فقال: “الشيوعية هي القوة للمجالس العمالية، والكهرباء التي تسري في عموم البلاد. لن تكون هناك شيوعية بدون كهرباء، بدون خطوط سكك حديدية، بدون إذاعة. لا يمكنك تأسيس نظام شيوعي في روسيا في القرن السادس عشر، لأن الشيوعية تستلزم تكديس المعلومات والموارد في مركز واحد. بدءا من قدرة الفرد، ووفقا لاحتياجاته” يعمل هذا النظام فقط عندما يمكن بسهولة جمع المنتجات وتوزيعها عبر مسافات شاسعة، وعندما يمكن رصد الأنشطة وتنسيقها عبر الدول بأكملها.
لقد فهم ماركس وأتباعه الحقائق التكنولوجية الحديثة والتجارب البشرية الجديدة، لذا كان لديهم إجابات ذات صلة بالمشاكل الجديدة للمجتمع الصناعي، وكذلك الأفكار حول كيفية الاستفادة من الفرص غير المسبوقة. لقد خلق الاشتراكيون دينًا جديدًا شجاعًا لعالم جديد شجاع. وتعهدوا بالخلاص من خلال التكنولوجيا والاقتصاد، وبذلك أسسوا أول دين تقني في التاريخ، وغيروا أسس الخطاب الأيديولوجي. قبل ماركس، عرّف الناس أنفسهم وانقسموا بحسب آرائهم حول الاله، وليس حول طرق الإنتاج. منذ عهد ماركس، أصبحت مسائل التكنولوجيا والبنية الاقتصادية أكثر أهمية وأكثر تسببا للأنقسام من النقاشات التي تدور حول الروح والحياة الآخرة. في النصف الثاني من القرن العشرين، أقحمت البشرية نفسها في جدال حول طرق الإنتاج. حتى أقسى منتقدي ماركس ولينين تبنوا موقفهم الأساسي تجاه التاريخ والمجتمع، وبدأوا يفكرون في التكنولوجيا والإنتاج بعناية أكثر من اهتمامهم بالاله والجنة.
في منتصف القرن التاسع عشر، كان عدد قليل من الناس على قدر من الإدراك مثل ماركس، وبالتالي عدد قليل فقط من البلدان خاضت تجربة التصنيع المتنامية. هذه الدول القليلة غزت العالم. وأخفقت معظم المجتمعات في فهم ما كان يحدث، ولذلك فاتها قطار التقدم.
ظلت هند داياناندا وسودان المهدي أكثر انشغالاً بالاله من المحركات البخارية، ومن ثم تم احتلالها واستغلالها من قبل بريطانيا الصناعية. في السنوات القليلة الماضية تمكنت الهند من إحراز تقدم كبير في سد الفجوة الاقتصادية والجيوسياسية التي تفصلها عن بريطانيا. أما السودان فلا تزال تكافح تخلفها.
–
في أوائل القرن الحادي والعشرين، بدأ قطار التقدم بمغادرة المحطة مرة أخرى – وربما يكون هذا آخر قطار على الإطلاق يغادر المحطة المسماة الانسان العاقل. أولئك الذين سيفوتون هذا القطار لن يحصلوا على فرصة ثانية. من أجل الحصول على مقعد، تحتاج إلى فهم تقنية القرن الواحد والعشرين، وعلى وجه الخصوص قدرات التكنولوجيا الحيوية وخوارزميات الكمبيوتر. هذه القوى أقوى بكثير من البخار والتلغراف، ولن تستخدم فقط لإنتاج الغذاء، المنسوجات، المركبات والأسلحة. ستكون المنتجات الرئيسية للقرن الحادي والعشرين هي الأجسام، الأدمغة والعقول، والفجوة بين أولئك الذين يتقنون هندسة الأجسام والأدمغة، والذين يجهلونها ستكون أكبر بكثير من الفجوة الواقعة بين بريطانيا التي تبجل ديكنز والسودان التي تبجل المهدي. في الواقع، ستكون الفجوة أكبر من الفجوة بين الانسان العاقل والنياندرتال. في القرن الحادي والعشرين، سيكتسب أولئك الذين يركبون قطار التقدم قدرات خارقة في الخلق والتدمير، في حين أن الذين سيتخلفون عنه سيواجهون خطر الانقراض.
فشلت الاشتراكية، التي كانت حديثة للغاية قبل مائة عام، في مواكبة التكنولوجيا الجديدة. لقد تبنى ليونيد بريجنيف وفيدل كاسترو الأفكار التي صاغها ماركس ولينين في عصر البخار، ولم يفهموا قوة الحواسيب والتكنولوجيا الحيوية. في المقابل، تكيف الليبراليون أفضل بكثير مع عصر المعلومات. يفسر هذا جزئياً لماذا لم نجح خروشوف في عام 1956، ولماذا كان الرأسماليون الليبراليون هم من دفنوا الماركسيين في نهاية المطاف. إذا عاد ماركس إلى الحياة اليوم، فإنه ربما يحث أتباعه القلة الباقين على تخصيص وقت أقل لقراءة كتابه داس كابيتال (رأس مال: نقد الاقتصاد السياسي) والمزيد من الوقت لدراسة الإنترنت والجينوم البشري.
يقف الإسلام المتطرف في وضع أسوأ بكثير من الاشتراكية. فهو لم يتصالح بعد مع الثورة الصناعية – ولا عجب في اهماله للهندسة الوراثية والذكاء الاصطناعي. لا يزال الإسلام والمسيحية والأديان التقليدية الأخرى تلعب دورا مهما في العالم. ومع ذلك، فإن دورهم يقتصر على التفاعل إلى حد كبير. في الماضي، كانت قوة خلاقة. على سبيل المثال، عندما قامت المسيحية بنشر الفكرة الهرطقية والتي تقتضي تساوي جميع البشر أمام الله، بالتالي تغيرت الهياكل السياسية البشرية، والتسلسل الهرمي الاجتماعي، وحتى العلاقات بين الجنسين. أما في شريعة العهد الجديد، ذهب يسوع إلى أبعد من ذلك، وأصر على أن الطبقة المسحوقة والمظلومة هم شعب الله المختار، وبالتالي قلب هرم السلطة على رأسه، وأشعل الشرارة لأجيال من الثوريين.
بالإضافة إلى الإصلاحات على الصعيد الاجتماعي والأخلاقي، كانت المسيحية مسؤولة عن الابتكارات الاقتصادية والتكنولوجية الهامة. لقد أنشأت الكنيسة الكاثوليكية نظامًا إداريًا أكثر تطوراً في أوروبا في العصور الوسطى، وكانت رائدة في استخدام المحفوظات والكتالوجات والجداول الزمنية وغيرها من تقنيات معالجة البيانات. في القرن الثاني عشر في أوروبا، كان الفاتيكان أقرب إلى أن يكون وادي السليكون. أسست الكنيسة أولى المؤسسات الاقتصادية الأوروبية – الأديرة – التي قادت على مدار ألف عام الاقتصاد الأوروبي وأدخلت أساليب زراعية وإدارية متقدمة. كانت الأديرة أول المؤسسات التي تستخدم الساعات، ولعدة قرون كانت الأديرة والمدارس الكاتدرائية من أهم مراكز التعليم في أوروبا، مما ساعد في تأسيس العديد من الجامعات الأوروبية الأولى، مثل بولونيا وأكسفورد وسلمانكا.
اليوم، لا تزال الكنيسة الكاثوليكية تتمتع بالولاء وضريبة العُشر التي تستحصلها من مئات الملايين من الأتباع. ومع ذلك، تحولت الديانات التوحيدية الأخرى منذ فترة طويلة من قوة خلاّقة إلى قوة متفاعلة. إنهم مشغولون بالحفاظ على التراث الديني أكثر من التقنيات الرائدة الجديدة، والأساليب الاقتصادية المبتكرة أو الأفكار الاجتماعية الرائدة. وهم في الغالب يتعارضون مع التقنيات والأساليب والأفكار التي تروجها الحركات الأخرى. يخترع علماء الأحياء حبوب منع الحمل – ولا يعرف البابا ما الذي يجب عمله حيال ذلك. يقوم علماء الكمبيوتر بتطوير الإنترنت – ويجادل الحاخامون بضرورة السماح لليهود الأرثوذكس بتصفحه. تشجع المفكرات النسويات النساء على تَمَلّك أجسادهن – بينما ينشغل المفتون بمناقشة كيفية مواجهة مثل هذه الأفكار الهدامة.
اسأل نفسك: ما هو أكثر الاكتشافات أو الاختراعات أو الإنشاءات تأثيراً في القرن العشرين؟ هذا سؤال صعب، لأنه من الصعب الاختيار بين قائمة طويلة من المرشحين، بما في ذلك الاكتشافات العلمية مثل المضادات الحيوية، والاختراعات التكنولوجية مثل أجهزة الكمبيوتر، والنتاجات الأيديولوجية مثل الحركة النسوية. اسأل نفسك الآن: ما هو أكثر الاكتشافات أو الاختراعات للديانات التقليدية تأثيراً، مثل الإسلام والمسيحية في القرن العشرين؟ هذا أيضا سؤال صعب جدا، لأن هناك عدد قليل جدا من الاختيارات للاختيار من بينها. ماذا اكتشف الكهنة والحاخامات والمفتيين في القرن العشرين التي يمكن مقارنتها في نفس الوقت بالمضادات الحيوية أو الحاسوب أو النسوية؟ بعد التفكير في هذين السؤالين، من أين ستندلع التغييرات الكبيرة في القرن الحادي والعشرين: من الدولة الإسلامية، أو من محرك الكوكل؟ نعم، يعرف تنظيم الدولة الإسلامية كيفية وضع مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب. لكن بغض النظر عن صناعة التعذيب، كم عدد النتاجات الجديدة المنبثقة من سوريا أو العراق مؤخرًا؟
يستمر مليارات الناس، بما في ذلك العديد من العلماء، في استخدام الكتب الدينية كمصدر للسلطة، لكن هذه النصوص لم تعد مصدرًا للإبداع. فكر، على سبيل المثال، حول قبول زواج المثليين أو كهنوتية المرأة من قبل فروع المسيحية الأكثر تقدمًا. من أين نشأ هذا القبول؟ ليس من قراءة الكتاب المقدس، القديس أوغسطين أو مارتن لوثر. بدلاً من ذلك، جاء من قراءة نصوص مثل ميشيل فوكو “تاريخ النشاط الجنسي” أو “بيان سايبورغ” الخاص بـ دونا هاراواي. ومع ذلك، فإن المؤمنين الحقيقيين المسيحيين – ومع ذلك التقدميون – لا يمكنهم الاعتراف بأن منظومتهم الأخلاقية ستكون مستمدة من فوكو وهراواي. لذا يعودون إلى الإنجيل، وإلى القديس أوغسطين وإلى مارتن لوثر، ويجرون بحثًا شاملًا للغاية. يقرأون صفحة تلو الأخرى وقصة تلو الأخرى بأقصى قدر من الاهتمام، حتى يجدون ما يحتاجون إليه: بعض الحِكم، أو حكاية رمزية، أو قانون، إذا ما تم تفسيره بشكل خلاق بما فيه الكفاية، فهذا يعني أن الله يبارك زواج المثليين، كما يمكن توسيم المراة للكهنوتية. ثم يزعمون أن الفكرة نشأت في الكتاب المقدس، في حين أنها نشأت في الواقع مع فوكو. يستمر الكتاب المقدس في كونه مصدر للسلطة، على الرغم من أنه لم يعد مصدرا حقيقيا للإلهام.
لهذا السبب لا تقدم الديانات التقليدية بديلاً حقيقياً لليبرالية. لا تحتوي كتبهم المقدسة على أي شيء عن الهندسة الوراثية أو الذكاء الاصطناعي، ومعظم الكهنة والحاخامات والمفتين لا يفقهون التقدم الخارق في علم الأحياء وعلوم الكمبيوتر. إذا كنت ترغب في فهم هذه الاختراقات، فلن يكون لديك الكثير من الخيارات – تحتاج إلى قضاء الوقت في قراءة المقالات العلمية وإجراء تجارب مختبرية بدلاً من حفظ النصوص القديمة ومناقشتها.
هذا لا يعني أن الليبرالية يمكن لها أن ترتكز على أمجادها. صحيح أنها فازت في حربها حول الدين، واعتبارًا من عام 2016، لا يوجد بديل لها. لكن نجاحها قد يختزن في داخله بذور الخراب. تدفع المثل الليبرالية المنتصرة الآن البشرية للوصول إلى الخلود والنعيم والألوهية. وبوجود رغبات الزبائن والناخبين المزعومة، فإن العلماء والمهندسين يكرسون المزيد والمزيد من الطاقات لهذه المشاريع الليبرالية. إلا أن ما يكتشفه العلماء وما يقوم المهندسون بتطويره قد يكشف عن كل الصدوع الملازمة لوجهة نظر العالم الليبرالي وعمى العملاء والناخبين. عندما تكشف الهندسة الوراثية والذكاء الاصطناعي عن كامل امكانياتها، فإن الليبرالية والديمقراطية والأسواق الحرة قد تصبح بالية مثل سكاكين الصوان وأشرطة الكاسيت والإسلام والشيوعية.
ناقش هذا الكتاب في مقدمته محاولة البشر لتحقيق الخلود والنعيم والالوهية في القرن الواحد والعشرين. هذا التوقع ليس مبتكرا أو ثاقب البصيرة. إنه يعكس ببساطة المُثل التقليدية للإنسانية الليبرالية. بما أن الإنسانية قدست الحياة والعواطف ورغبات البشر، فمن غير المستغرب أن تسعى الحضارة الإنسانية لاطالة أمد الحياة، السعادة والقوة البشرية. ومع ذلك، فإن الجزء الثالث والأخير من الكتاب سيزعم أن محاولة تحقيق هذا الحلم الإنساني سيقوض أسسها، من خلال إطلاق العنان لما بعد الانسانية.
لقد مكننا الإيمان الإنساني بالمشاعر من الاستفادة من نِتاج الميثاق الحديث دون دفع الثمن. لا نحتاج إلى أي آلهة تُقيّد قوتنا وتعطينا معنى – فالخيارات الحرة للزبائن والناخبين تزودنا بكل المعنى الذي نحتاجه. ماذا سيحدث عندما ندرك أنهم ليسوا أحرارا في خياراتهم مطلقًا، أو عندما نخلق التكنولوجيا اللازمة لحساب، تصميم أو التفوق على مشاعرهم؟ إذا كان الكون كله مرتبطًا بالتجربة الإنسانية، فما الذي سيحدث بمجرد أن تصبح التجربة البشرية مجرد منتج آخر قابل للتصميم، لا يختلف جوهريًا عن أي عنصر آخر في الأسواق؟
 Iraqi Translation Project لأن عقوداً من الظلام الفكري لا تنتهي إلا بمعرفة الأخر الناح..لابد من الترجمة
Iraqi Translation Project لأن عقوداً من الظلام الفكري لا تنتهي إلا بمعرفة الأخر الناح..لابد من الترجمة