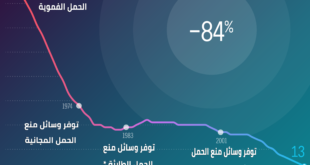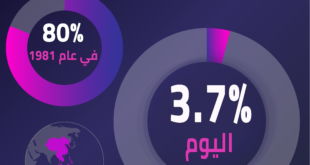نشر في صحيفة “ذي ايكونوميست” بتاريخ: 6/8/2018
ترجمة: ياسين ادوحموش
تصميم الصورة: أسماء عبد محمد
سطع نجم “يوفال حراري” المؤرخ بالتدريب، بفضل اثنين من الكتب الأكثر مبيعاً، حيث بحث كتابه “العاقل” في ماضي الإنسانية، بينما بحث كتاب “الهوموديوس” في مستقبلها، ويتأمل كتابه الأخير “21 درسًا للقرن الحادي والعشرين”، في هذا الزمان والمكان، مغطياً مواضيع شتى من التكنولوجيا والإرهاب إلى الشعوبية والدين.
يدرس يوفال حراري، في المقتطف التالي، الفرضية الأساسية للهجرة وما قد يدين به المهاجرون والمجتمعات لبعضهم البعض، مختتماً بالقول :”سيكون من الخطأ أن نرفض كل مناهضي الهجرة باعتبارهم “فاشيين”، تماماً كما سيكون من الخطأ تصوير جميع المؤيدين للهجرة على أنهم ملتزمون “بالانتحار الثقافي”. […] إنها مناقشة بين موقفين سياسيين شرعيين ، يجب أن يتم البت فيهما من خلال إجراءات ديمقراطية قياسية”.
غالباً ما يتحول النقاش الأوروبي حول الهجرة إلى لعبة صراخ لا يَسمع فيها أي طرف رأي الآخر. لتوضيح الأمور، قد يكون من المفيد النظر إلى الهجرة باعتبارها صفقة تنطوي على ثلاثة بنود أو أحكام أساسية:
البند الأول: يسمح البلد المضيف للمهاجرين بالدخول.
البند اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ أن ﻳﺘﺒﻨﻮا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ كان ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻗﻮاﻋﺪهم وﻗﻴﻤﻬﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
البند اﻟﺜﺎﻟﺚ: إذا اندمج اﻟﻤﻬﺎﺟﺮون ﺑﺪرﺟﺔ كاﻓﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺼﺒﺤﻮن ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ أﻋﻀﺎء ﻣﺴﺎوﻳﻴﻦ وكاﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ. “هم” يصبحون”نحن”.
هذه البنود الثلاثة تؤدي إلى ثلاثة مناقشات متميزة حول المعنى الدقيق لكل بند:
المناقشة الأولى: تنص الفقرة الأولى من اتفاق الهجرة ببساطة على أن البلد المضيف يسمح للمهاجرين بالدخول. ولكن هل ينبغي فهم ذلك باعتباره واجباً أو خدمة؟ هل الدولة المضيفة مضطرة لفتح أبوابها أمام الجميع، أم أن لها الحق في الاختيار والانتقاء، وحتى وقف مسلسل الهجرة نهائياً؟ يبدو أن الموالين للهجرة يعتقدون أن على الدول واجباً أخلاقياً يملي عليها قبول ليس فقط اللاجئين، بل أيضا الناس من الأراضي المنكوبة بالفقر الذين يبحثون عن وظائف ومستقبل أفضل. خاصة في عالم يتسم بالعولمة، فإن لدى جميع البشر التزامات أخلاقية تجاه جميع البشر الآخرين، والذين يتهربون من هذه الالتزامات هم من الأنانيين أو حتى من العنصريين.
يرُد المعادون للهجرة أنه، ربما باستثناء حالة اللاجئين الفارين من الاضطهاد الوحشي في بلد مجاور، فالمرء ليس مجبراً على فتح بابه. قد يكون على تركيا واجب أخلاقي للسماح للاجئين السوريين اليائسين بعبور حدودها، ولكن إذا حاول هؤلاء اللاجئون الانتقال إلى السويد، فإن السويديين غير ملزمين بقبولهم. أما بالنسبة للمهاجرين الذين يبحثون عن عمل ورفاهية، فإن الأمر عائد تماماً للبلد المضيف سواء أراد ذلك أم لا، وفي ظل أي ظروف.
يؤكد مناهضو الهجرة أن إحدى الحقوق الأساسية لكل جماعة بشرية هي الدفاع عن نفسها ضد الغزو، سواء اتخذ شكل جيوش أو مهاجرين. لقد عمل السويديون بجد كبير وقدموا تضحيات عديدة من أجل بناء ديمقراطية ليبرالية مزدهرة، وإذا فشل السوريون في فعل نفس الشيء، فهذا ليس خطأ السويد. إذا كان الناخبون السويديون لا يريدون المزيد من المهاجرين السوريين – لأي سبب كان – فإن من حقهم رفض دخولهم، وإذا قبلوا ببعض المهاجرين، فينبغي أن يكون واضحاً تماماً أن هذه مصلحة تفضلها السويد وليست واجباً عليها، مما يعني أن المهاجرين الذين يُسمح لهم بالدخول إلى السويد يجب أن يشعروا بالامتنان الشديد لأي شيء يحصلون عليه، بدلاً من أن يأتوا مع قائمة مطالب كما لو كانوا يملكون المكان.
علاوة على ذلك، كما يقول مناهضو الهجرة، يمكن لأي بلد أن يمتلك أي سياسة للهجرة يريدها، ويفحص ليس فقط السجلات الجنائية أو المهارات المهنية للمهاجرين، ولكن حتى أشياء من قبيل الدين. إذا أراد بلد مثل إسرائيل السماح بدخول اليهود فقط، و أن يوافق بلد مثل بولندا على استيعاب اللاجئين من الشرق الأوسط بشرط أن يكونوا مسيحيين ، فإن هذا قد يبدو بغيضاً، لكنه يقع بشكل كامل ضمن نطاق حقوق الناخبين الإسرائيليين أو البولنديين.
ما يزيد من تعقيد الأمور هو أن الناس في كثير من الحالات يريدون أن يحتفظوا بالكعكة ويأكلوها في آن واحد. تغض العديد من البلدان الطرف عن الهجرة غير القانونية، أو حتى تقبل العمال الأجانب على أساس مؤقت، لأنهم يريدون الاستفادة من طاقة ومواهب الأجانب والعمالة الرخيصة. مع ذلك، ترفض الدول بعد ذلك تقنين وضع هؤلاء الأشخاص، قائلة إنهم لا يريدون الهجرة. يمكن أن يخلق ذلك، على المدى الطويل، مجتمعات ذات تسلسل هرمي تستغل فيها طبقة عليا من المواطنين الكاملين طبقة من الأجانب الذين لا حول لهم ولا قوة، كما يحدث اليوم في قطر والعديد من دول الخليج الأخرى.
طالما لم يتم تسوية هذه المناقشة، فمن الصعب للغاية الإجابة عن جميع الأسئلة اللاحقة حول الهجرة. ولما كان المؤيدون للهجرة يعتقدون أن الناس لديهم الحق في الهجرة إلى أرض أخرى إذا رغبوا في ذلك، وعلى الدول المضيفة واجب استيعابهم، فإنهم يتصرفون بغضب أخلاقي عندما يُنتهك حق الناس في الهجرة، وعندما تفشل الدول في القيام بواجب الاستيعاب. إن معارضي الهجرة مذهولون بمثل هذه الآراء، حيث إنهم يرون الهجرة باعتبارها امتياز، والامتصاص باعتباره خدمة. لماذا يتم اتهام الناس بكونهم عنصريين أو فاشيين لمجرد أنهم لا يسمحون للآخرين بالدخول إلى بلدهم؟
بالطبع، حتى إذا كان السماح للمهاجرين يعد مصلحة وليس واجباً، فبمجرد أن يستقر المهاجرون في البلد المضيف فإنهم يتحملون تدريجيا العديد من الواجبات تجاههم وأبنائهم. وبالتالي، لا يمكن للمرء تبرير معاداة السامية في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم من خلال القول: “أسدينا لجدتك الكبرى معروفاً من خلال السماح لها بالدخول إلى هذا البلد في عام 1910، لذا يمكننا الآن أن نتعامل معك بالطريقة التي نرغب بها”.
المناقشة الثانية: تنص الفقرة الثانية من اتفاق الهجرة على أنه إذا تم السماح للمهاجرين بالدخول، فإن على عاتقهم الالتزام بالاندماج في الثقافة المحلية. لكن إلى أي مدى يجب أن يكون الاندماج؟ إذا انتقل المهاجرون من مجتمع أبوي إلى مجتمع ليبرالي، فهل يجب أن يصبحوا نسويين؟ إذا كانوا قادمين من مجتمع متدين للغاية، فهل سيحتاجون إلى تبني نظرة علمانية للعالم؟ هل يجب أن يتخلوا عن قواعد اللباس التقليدية والمحرمات الغذائية؟ يميل مناهضو الهجرة إلى وضع الحاجز على مستوى عالي، في حين يضعه الموالون للهجرة على مستوى أقل بكثير.
يجادل مؤيدو الهجرة بأن أوروبا نفسها شديدة التنوع، وأن سكانها الأصليين لديهم مجموعة واسعة من الآراء والعادات والقيم. هذا بالضبط هو ما يجعل أوروبا نابضة بالحياة وقوية. لماذا يجب أن يُجبَر المهاجرون على التمسك بهوية أوروبية وهمية لا يرقى إليها سوى عدد قليل من الأوروبيين؟ هل تريد إجبار المهاجرين المسلمين إلى المملكة المتحدة على أن يصبحوا مسيحيين، في حين لا يذهب الكثير من المواطنين البريطانيين إلى الكنيسة؟ إذا كان لأوروبا أي قيم جوهرية حقيقية فهي القيم الليبرالية للتسامح والحرية، والتي تعني أن الأوروبيين يجب أن يُظهروا قدراً من التسامح تجاه المهاجرين أيضًا، وأن يسمحوا لهم بأكبر قدر ممكن من الحرية في اتباع تقاليدهم، بشرط ألا تضر هذه القيم حريات وحقوق الآخرين.
يتفق معارضو الهجرة على أن التسامح والحرية هما من القيم الأوروبية الأكثر أهمية، ويتهمون العديد من مجموعات المهاجرين – خاصة من الدول الإسلامية – بالتعصب وكراهية النساء ورهاب المثلية ومعاداة السامية. ولأن أوروبا تعتز بالتسامح، فإنها لا تسمح بوجود الكثير من الأشخاص المتعصبين. في حين أن المجتمع المتسامح قادر على إدارة الأقليات الصغيرة غير الليبرالية، إذا تجاوز عدد هؤلاء المتطرفين عتبة معينة، فإن طبيعة المجتمع بأكملها تتغير. إذا سمحت أوروبا بالعديد من المهاجرين من الشرق الأوسط، فسوف ينتهي الأمر بأن تصبح أوروبا مثل الشرق الأوسط.
يذهب بعض مناهضي الهجرة الآخرين أبعد من ذلك بكثير، إذ يشيرون إلى أن المجتمع الوطني أكثر بكثير من مجرد مجموعة من الناس الذين يتسامحون مع بعضهم البعض، ومن ثم لا يكفي أن يلتزم المهاجرون بالمعايير الأوروبية للتسامح، كما يجب أن يتبنوا العديد من الخصائص الفريدة للثقافة البريطانية أو الألمانية أو السويدية، أيا كانت هذه الخصائص. من خلال السماح لهم بالدخول، تأخذ الثقافة المحلية على عاتقها مخاطرة كبيرة ونفقات ضخمة، فما من سبب يحول دون أن تدمر نفسها كذلك. إنها تقدم مساواة كاملة ونهائية لذا فإنها تطلب الاندماج الكامل. إذا كان لدى المهاجرين مشكلة مع بعض العادات الغربية في الثقافة البريطانية أو الألمانية أو السويدية ، فإنهم مدعوون للذهاب إلى مكان آخر.
تتمثل القضيتان الرئيسيتان في هذه المناقشة في الخلاف حول عدم التسامح مع المهاجرين والخلاف حول الهوية الأوروبية. إذا كان المهاجرون بالفعل متهمين بالتعصب غير القابل للشفاء، فإن العديد من الأوروبيين الليبراليين الذين يفضلون الهجرة في الوقت الحالي سوف يُجرون عاجلاً أم آجلاً على معارضتها بضراوة. وعلى العكس من ذلك، إذا أثبت معظم المهاجرين أنهم متحررون وواسعوا الأفق في موقفهم حيال الدين والجنس والسياسة، فإن هذا سيؤدي إلى تعطيل أكثر الحجج فعالية ضد الهجرة.
ومع ذلك، سيظل الباب مفتوحًا أمام مسألة الهوية القومية الفريدة لأوروبا. يعد التسامح قيمة عالمية. هل هناك أي قواعد وقيم فرنسية فريدة يجب قبولها من قبل أي شخص مهاجر إلى فرنسا، وهل هناك قواعد وقيم دنماركية فريدة يجب على المهاجرين أن يتبنوها؟ طالما أن الأوروبيين منقسمون بشدة حول هذه المسألة، فإنهم بالكاد يستطيعون اتباع سياسة واضحة حول الهجرة. وعلى العكس، بمجرد أن يعرف الأوروبيون من هم، فإن 500 مليون أوروبي لن يواجهوا صعوبة في استيعاب بضعة ملايين من اللاجئين – أو إبعادهم.
المناقشة الثالثة: تنص الفقرة الثالثة من اتفاق الهجرة على أنه إذا قام المهاجرون بالفعل ببذل جهود مخلصة للاندماج – ولا سيما تبني قيمة التسامح – فإن الدولة المضيفة ملزمة بأن تعاملهم كمواطنين من الدرجة الأولى. لكن، كم من الوقت بالضبط يجب أن يمر قبل أن يصبح المهاجرون أعضاء كاملين في المجتمع؟ هل يجب أن يشعر المهاجرون من الجيل الأول من الجزائر بالظلم إذا لم يُنظر إليهم على أنهم فرنسيون بالكامل بعد قضائهم عشرين عامًا في البلاد؟ ماذا عن الجيل الثالث من المهاجرين الذين جاء أجدادهم إلى فرنسا في السبعينيات؟
يميل مؤيدو الهجرة إلى المطالبة بقبول سريع، بينما يريد المناهضون للهجرة فترة اختبار أطول بكثير. بالنسبة إلى الموالين للهجرة، إذا لم يُنظر إلى المهاجرين من الجيل الثالث ولم يعاملوا كمواطنين متساوين، فهذا يعني أن البلد المضيف لا يفي بالتزاماته، وإذا كان هذا يؤدي إلى التوترات والعداء وحتى العنف – فإن البلد المضيف لا يحمل أي شخص مسؤولية ذلك سوى تعصبها. بالنسبة لمناهضي الهجرة، تشكل هذه التوقعات المبالغ فيها جزءًا كبيرًا من المشكلة، حيث يجب أن يكون المهاجرون صبورين. إذا وصل أجدادك إلى هنا منذ أربعين عامًا فقط، وأنت الآن ترتكب أعمال شغب في الشوارع لأنك تعتقد أنك لا تعامل كمواطن، عندها تكون قد فشلت في اجتياز الاختبار.
تتعلق القضية الجذرية لهذه المناقشة بالفجوة بين المقياس الزمني الشخصي والمقياس الزمني الجماعي. من وجهة نظر التجمعات البشرية، تعد أربعون عاما فترة قصيرة. من الصعب أن نتوقع من المجتمع استيعاب مجموعات أجنبية بشكل كامل في غضون بضعة عقود، إذ استغرقت الحضارات السابقة التي استوعبت الأجانب وجعلتهم مواطنين متساوين – مثل إمبراطورية روما، والخلافة الإسلامية، والإمبراطوريات الصينية والولايات المتحدة – قرونًا بدلاً من عقود لتحقيق هذا التحول.
ومع ذلك، من وجهة نظر شخصية، يمكن أن تكون أربعون دهراً من الزمن. بالنسبة لمراهقة وُلدت في فرنسا بعد عشرين عاماً من هجرة أجدادها، فإن الرحلة من الجزائر العاصمة إلى مرسيليا باتت من الماضي البعيد، إذ إنها وُلدت هنا، وجميع أصدقائها قد ولدوا هنا، كما أنها تتحدث الفرنسية بدلاً من العربية، ولم تطئ قدمها الجزائر قط. إن فرنسا هي المنزل الوحيد الذي عرفته. والآن يقول لها الناس إن هذا ليس منزلها، وأنها يجب أن “تعود” إلى مكان لم تسكنه أبداً؟
طالما أننا لا نعرف ما إذا كان الاستيعاب واجبًا أو معروفاً، ومستوى الاستيعاب المطلوب من المهاجرين، ومدى سرعة معاملة الدول المضيفة لهم كمواطنين متساوين – فلا يمكننا الحكم على ما إذا كان الطرفان يفيان بالتزاماتهما.
هناك مشكلة إضافية تتعلق بالمحاسبة. فعند تقييم صفقة الهجرة، يولي كلا الجانبين أهمية أكبر بكثير للانتهاكات أكثر من الامتثال. إذا كان مليون مهاجر من المواطنين ملتزمين بالقانون، لكن مائة مهاجر انضموا إلى جماعات إرهابية وهاجموا البلد المضيف، فهل يعني ذلك أن المهاجرين يمتثلون بشكل عام لشروط الصفقة، أو ينتهكونها؟ إذا كانت مهاجرة من الجيل الثالث تسير في الشارع ألف مرة دون أن تتعرض للتحرش، ولكنها تتعرض بين الفينة والاخرى لصيحات عنصرية، فهل يعني ذلك أن السكان الأصليين يقبلون المهاجرين أم يرفضونهم؟
مهما كانت إجاباتك على هذه الأسئلة، يجب أن يكون من الواضح على الأقل أن الجدل الأوروبي حول الهجرة أبعد ما يكون عن كونه معركة واضحة المعالم بين الخير والشر. سيكون من الخطأ أن نرفض جميع مناهضي الهجرة بوصفهم “فاشيين”، تماماً كما قد يكون من الخطأ تصوير كل مؤيدي الهجرة على أنهم ملتزمون “بالانتحار الثقافي”. لذلك، لا ينبغي أن يدور الجدل حول الهجرة بوصفها نضالاً لا هوادة فيه حول ضرورة أخلاقية غير قابلة للتفاوض. إنها مناقشة بين موقفين سياسيين شرعيين، يجب أن يتم البت فيهما من خلال إجراءات ديمقراطية قياسية.
مقتطف من كتاب “21 درسا للقرن الواحد والعشرين”. 2018 يوفال حراري.
المصدر: هنا
 Iraqi Translation Project لأن عقوداً من الظلام الفكري لا تنتهي إلا بمعرفة الأخر الناح..لابد من الترجمة
Iraqi Translation Project لأن عقوداً من الظلام الفكري لا تنتهي إلا بمعرفة الأخر الناح..لابد من الترجمة