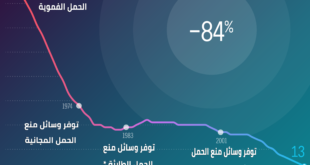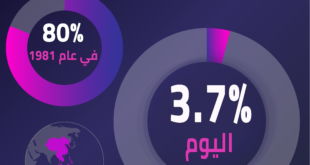كتبه لمجلة أمريكان ساينتيت: روبرت لويس شيانيس
مقال بتاريخ: آب_2016
ترجمة: منار ابراهيم
تصميم: حسام زيدان
يمكن للاعترافات العلنية بالأخطاء المُمارسة ضد الطبيعة تعزيز الوعي البيئي والالتزام به والعمل نحو تحقيقه.
وما كدت أن أعبر القناة من مقاطعة فينتورا الواقعة بولاية كاليفورنيا إلى الحديقة الوطنية لجزر القناة في صباح يوم ضبابي للعام المُنصرم، حتى أدركت أن قائد قارب النزهة خاصتنا كان نفسه قائد قارب صيد السمك الذي كنت أستقله سابقًا، والغريب أنه كان في المحيط ذاته. فاقتربت منه مستفهمًا عمّا إذا كان قد هجر مهنة الصيد. فأجاباني آسفًا أنه لم يجد سوى ذلك سبيلًا، وعن السبب قال مُفصلًا:
“حقيقة الأمر أنني لم أستطع الانحياز إلى صفوف المشاهدين لأرى كل ذلك العبث والإهدار للثروة السمكية يحدث أمام ناظري. فمثلًا تجد بعض الأشخاص اللطفاء مَن عزموا على قضاء يوم ممتع في الصيد، لا ينفك الواحد منهم يصطاد الكثير والكثير من الأسماك حتى دون الحاجة إليها؛ ظنًا منهم أنهم بذلك يستمتعون بقاء يوم جيد.
بل والأنكى من ذلك أن تجد بعض الصيادين يدفعون نفقات إضافية لأشخاص آخرين رغبة منهم في صيد أسماك أكثر دون تجاوز الحد المسموح.”
فأجبته أنني لما يقول مُتفهمًا. إذ كنت أفعل الشئ ذاته عندما يحالفني الحظ وتمتلئ شباكي بالأسماك. فكنت أحتفظ بالكبير منهم وأعطيهم الصغير. في الواقع، لقد كان فعلًا خبيثًا وغير حسن بالمرة. ثم استأنف القبطان حديثه قائلًا:
”لأصارحك القول، أنني لم أكن معارضًا للموقف تمامًا، ولكن بحلول مواسمٍ معينة، تغدو هناك وفرة في أعداد حيوان الحبار المائي والذي يُدعى بـ”حبار هومبولت الأبيض الضخم”، وعليه يكون الهالك من تلك الحيوانات كثيرٌ للغاية. وقلة فقط من يأخذونهم إلى المنزل، لذا حالما ينصرفون، ينتهي بي الأمر أنا وطاقمي قابعين بين كم هائل من تلك الحيوانات النافقة على متن القارب، وبالطبع لن يفكر أي منّا كذلك في اصطحابهم إلى المنزل. وبتكرار ذلك السيناريو كل يوم، لم يعُد بوسعي التحمل أو الاستمرار في المهنة، لذا حاولت جاهدًا الانصراف عن الأمر برمته وهجر الصيد. ولم يكن ذاك باليسير أو الهين على الإطلاق، لأنني كنت أعشق الصيد، لذا فلم أجد من شَرَكه خلاصًا. ولكن للأسف، راحت الحيوانات البحرية ضحية الممارسات الخاطئة لتلك الرياضة الرائعة.
واستمر الحال كما هو عليه ولم أكن قد تركت المهنة بعد، إذ آثرت البقاء عليها لبعض الوقت عسى أن يطرأ تغير ما، ولم يدم الحال طويلًا إذ لاحظت أننا نبالغ في اصطياد الأسماك؛ الصغير منها قبل الكبير، ومع ذلك لم نكن لنتجاوز الحدود المقررة. وعزمت حينها على ترك المهنة تمامًا بلا رجعة مع أن القارب وقتها كان يفيض بحيوان الحبار الضخم.“
اللافت للنظر حقًا في قصة القبطان هو الطريقة التي عزم بها على هجر مهنة الصيد. والتي لم تكن استجابة لقوانين تنصها الحكومة أو من جراء تقريع أو إكراه على فعل ذلك. بل فعلها من تلقاء نفسه ومحض إرادته الحرة. وللحق أنني أراه منطقيًا للغاية، فلنفس تلك الأسباب التي ذكرها قمت بالشئ ذاته.
وجدير بالذكر أن تلك القصص التي تُروى على ألسنة من كانوا يومًا مُسيئين في حق الطبيعة قد يُبنى على أساسها جزء كبير من الحركة البيئية الحديثة.
ولكن، مع ذلك، نظل في كثير من الأحيان عالقين في خضم ممارساتنا الخاطئة، والتي غالبًا ما نتجاهل عواقبها تمامًا. نرتكب كل يوم العديد من الجنايات ضد البيئة، كبيرة كانت أو صغيرة. وبكلامي هذا لا أشير إلى أحدًا بعينه. فجميعنا مجرم في حق الطبيعة ولا أستثني نفسي من هذا: فأنا لازلت أتناول اللحوم، بما فيها الأسماك. كما اشتريت سيارة هجينة (هايبرد) جديدة – حفاظًا على البيئة – إلا أنني لازلت محتفظًا بشاحنة قديمة للمرح والرحلات (ذات إضاة عالية الكفاءة). أمشي لممارسة الرياضة، ولكن ألا يمكننا المشي كذلك لإنجاز مهماتنا بدلًا من استخدام وسائل النقل؟! وكمواطن كاليفورني ذا وعي بمخاطر الجفاف، يكون علىّ تفريغ كل دلو ارتشاح كامل من حوض مطبخنا إلى الخارج لري نباتات الحديقة، ولكن أخشى أنني لا أفعل ذلك، ففي كل مرة، لا أعتقد أنني أتمتع بالنشاط الكافِ للقيام بتلك الأمور التي من شأنها توفير المياه.
وكل تلك الأعمال مجتمعة لابد وأن لها آثار عميقة على نطاق عالمي. ويحذر العلماء من أننا بدأنا نعاني بالفعل من بعض آثار اضطراب المناخ العالمي من جراء النشاط البشري، مثل ذوبان الأنهار الجليدية وارتفاع مستويات سطح البحر وزيادة تواتر الظواهر المناخية القاسية. ناهيك عن أننا – نمر في ظل الوقت الراهن – بعصر”انقراضنا السادس” على كوكب الأرض، وبسرعة انقراض تزيد 100 مرة عن ذي قبل، أي قبل ظهور الإنسان المعاصر. ولكن هل من سامعٍ أو مجيب؟ فللأسف لا نرى أي جماعات يساورها القلق أو يدفعها الحماس للتعامل مع تلك الكارثة المُحتمة – التي تسببنا بها – والتي عاجلًا ما ستقضي علينا وتُبيدنا كما الديناصورات. حسنًا فلِمَ الانتظار الآن؟ ألم يأن لنا الاستيقاظ من سباتنا هذا الذي طال أمده؟ هل مازلنا بحاجة إلى مزيد من الإحصائيات أو التحذيرات المبنية على الحقائق أو المزيد من علم المناخ أو التغطية الإخبارية؟!
ما رأيكم بأن نجرب وسيلة جديدة: ألا وهي تحويل القضية إلى أمر شخصي. فكما تعلم أن القصة القصيرة التي رواها قائد القارب عمّا فعل هي اعتراف شخصي. وقد خلفت في نفسي أثرًا لما اتخذه من قرار في ترك عالم الصيادين المثير والمفعم بالحماس والانتقال إلى عالم آخر يكتنفه الهدوء النسبي والسكون…وكل ذلك قاله بأسلوبه الخاص خلال القصة بأكملها. فضلًا عن أنه لم يكن يعظ أو ينصح، بل كان يخبر عميله السابق فقط ما أحدث في نفسه جل هذا التغيير، وهذا الحوار بيننا الذي لم يدُم طويلًا أشار إلي أننا نفهم بعضنا بعضا.
فقد استشعرت منه قربًا بدرجة لم أكن لأتوقعها، وكان علىّ التطوع بسرد قصتي أنا الآخر حول قلقي بشأن إهدار موارد المحيط الثمينة.
فمثل تلك القصص تكون ذات وقع خاص علينا وتجذبنا نحوها لنقع في أسرها ونرتبط بتفاصيل الشخصية والموقف بطريقة لا تقوى على تحقيقها التغطيات الإعلامية الخاصة بالانتهاكات ضد الطبيعة.
حيث أن الاستماع إلى قصص اعترافات شخصية حول التجاوزات ضد الطبيعة يمكنه حث الآخرين على إعادة تقييم علاقتهم مع العالم الطبيعي، لربما يفيقوا من سباتهم وتُفتح أعينهم على ما أحدثوه من أضرار بالغة وهم في غفلة ساهون، ولربما – في بعض الأحيان – يقرون بخطئهم ويبحثوا عن شتى السبل راجين الصفح والمغفرة عمّا ارتكبوه من جرائم.
فن سرد القصص وقوته.
ولتتعلم كيفية فن سرد القصص باحترافية مع إمكانية إضفاء طابع شخصي عليها لتكون آكثر تأثيرًا وإقناعًا، عليك بالعلماء والشعراء؛ فلن تجد أفضل منهم معلمًا. والسبب بسيط للغاية، إذ أن الشعر والأدب والدراما وغيرهم من مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية قائم على القصص ذات التأثيرات العاطفية سريعة المفعول. كما أن تلك الأشكال الفنية تُلم بقضايا الحياة والموت وكل ما بينهما من مسميات شخصية. فكما يظهر في الأعمال الفنية، تراهم يضعون أشخاص محددة في خضم صراعات إنسانية ويدعونا نشاهدهم يتلوون ويتحولون ويعانون آلام الصدام مع الصراع الناشب. وقد يحدث وأن تدمر تلك الصراعات صاحبها وتقضي عليه، إلا أنها في المقابل تنير عقله وتفتح بصيرته للتقبل الذاتي والتحلي بالحكمة – والذي هو مفيد لكلانا.
وربما لن تجد مثالًا أفضل في هذا الصدد – وهو الاعتراف بالإساءة البيئية – من قصيدة صموئيل تايلور كولريدج ” قافية البحّار القديم.“ فمع أن قصيدة مثل تلك ذات عمر يناهز 200 عام قد تبدو مكانًا غير مألوف لإيجاد الإلهام نحو حركة بيئية حديثة، كما تُعد قصة كولريدج نفسه خير مثال على كيفية الاعتراف بالانتهاكات البيئية.
ناهيك عن أن تلك القصيدة التي مثلت بداية الأدب الرومانسي البريطاني والتي نُشرت في ديوان قصائد غنائية عام (1798) انتهجت مسار شخص ينتهك العالم الطبيعي ويعيث فيه فسادًا. إذ كان طائر القطرس – رفيق درب البحار – يُعتقد أنه المسؤول عن جلب الرياح التي تقود السفينة بعيدًا عن القطب الجنوبي المتجمد. وما كان من البحار حينئذ إلا أن يتناول قوسه مُعلنًا الحرب على تلك الطيور التي تخوض معه غمار رحلته ليرديهم بلا هوادة أو تفكير قتلى واحد تلو الآخر. ليتلو ذلك ارتفاع شديد في حرارة الطقس وندرة في سقوط الأمطار. وحول رقبة البحار، يعلقون طائر القطرس. ومن المسؤول عن ركود العمل وارتفاع درجة الحرارة والملوم في اعتقادهم؟ بالطبع ذلك الطائر المسكين. (ومذ ذاك اليوم وحتى يومنا هذا، ما فتئ “طائر القطرس” يُستخدم كاستعارة لعدوان إجرامي مشين لا يقوى على طيه النسيان – ففيه ميثاق على القوة التي لا تزال تتسم بها تلك القصيدة لقرون عدة بعد كتابتها.)
تساقط أفراد طاقم السفينة كلهم صرعى، ليغدو البحار “وحيدًا في عرض البحر”. وفي ثنايا الليل، يلحظ البحار المنعزل وميض “الثعابين المائية” بألوانها البراقة والمتلألئة، وبجمالهم الأخاذ سلبوا لبّه، فتراه مستغرقًا في مراقبتهم بابتهاج ويباركهم”دون وعي منه بذلك”. وفي ذات اللحظة يسقط الطائر من على رقبته في البحر وتغدق عليه السماء بما تحمل في ثنايا سحبها. مع أننا لازلنا في منتصف القصيدة، إلا أنه يمكننا التكهن بما سنراه يحدث في الختام ومغزاه الأخلاقي البليغ لحب الطبيعة الجذري الذي اجتاح البحار: نحن بحاجة إلى حب “كل الأشياء الكبير منها والصغير على حد سواء” لسلامة صحتنا وبقائنا على وجه البسيطة.
وبعدها يقضي البحار حياته طائفًا مجاهرًا بخطئيته ساردًا كما المجنون رؤيته للطبيعة. ونسمع حكايته بينما يعيد قصها على ضيف مجهول في طريقه إلى حفل زفاف. لدرجة أن الضيف لم يستطع حضور حفل الزفاف وقد غادر مرسوم على وجه آثار الذهول والاندهاش ممّا قص عليه الرجل المجنون لتوه. يبدو أنه لم يكن على استعداد كافٍ لاستئناف حياته الاجتماعية وتقاليده الثقافية مثل الزواج وكان بحاجة لبعض الوقت لاستعادة عافيته. ولنكن واضحيين، فذلك التأثير لن يدفعه مثلًا للخروج في رحلة استكشافية لإنقاذ طيور القطرس، ولكنه على الأقل سيثير في نفسه تساؤل حول ما إذا كان يحب كل المخلوقات كبيرة كانت أم صغيرة. فهذا هو التأثير الذي تُخلّفه مثل تلك القصص الفعالة والمؤثرة التي تدور حول العدوان الشخصي على الحياة الطبيعية والتحول بعدها إلى النقيض.
وقد طوّع العديد من الكتاب البيئيين في العصر الحديث استراتيجيات مماثلة لرواية القصص للاعتراف علنًا بجرائمهم المُشينة ضد العالم الطبيعي. وفي كتاب “ساند كونتي ماناك أند سكيتشس هير أند ذير” الصادر عام 1949 – الذي باع أكثر من مليوني نسخة، وساعد في تأسيس حركة صيانة الأنهار والغابات الحديثة – وَصَف عالم البيئة الشهير ألدو ليوبولد كيف أنه قام مرة بـ”إطلاق رصاص” على قطيع من الذئاب “مدفوعًا بالإثارة أكثر منه بالدقة”، ليخلص بعدها إلى إدراك آخر حول أهمية كل مخلوق مترابط في النظام البيئي. وفي كتاب “طبيعة أخرى” الصادر عام 1991، ذكر الصحفي الشعبي مايكل بولان كيف أصبح مهووسًا بإبادة الفأر الخشبي من حديقته، والذي – بحسب اعترافه – “جعله يرى كم السواد الذي نحمله داخلنا – في بعض المواقف – تجاه الطبيعة: فعنادها الذي يدفعنا للجنون، وكيف أننا على استعداد لإبادتها، وسعينا الدؤوب نحو بعض الأهداف قصيرة المدى يوضح ذلك جيدًا.” فعبر سرد قصصهم، ألهم الكتاب البيئيين غيرهم للتفكير وإعادة النظر في تجاوزاتهم وانتهاكاتهم الخاصة ضد الطبيعة.
تأثير فيلم بلاكفيش
لعل الأفلام الوثائقية هي أحد أبرز وأقوى المنصات الحديثة لسرد القصص. فقد ساعدت تلك الأفلام في إلهام الجمهور لدفع الأنظمة البيئية، بما في ذلك تأمين حماية أفضل للحيوانات مثل الأفيال والقرود العليا. إذ يلتقط الفيلم الوثائقي بلاكفيش – الصادر عام (2013) – في أحد التكرارات الحالية لتحقيق حكاية كولريدج الأسطورية في العلاقة الإنسانية مع الطبيعة، نقطة تحول يدرك عندها العديد من مدربي حدائق سي وورلد البحرية مدى قسوة حبس الحيتان القاتلة في صهاريج المياه وكذلك كم المخاطر الهائلة التي تشكلها تلك الحيتان على حياة الموظفين.
ويركز الفيلم على حادثة قتل الحوت تيليكوم للمدربة داون برانكو في عام 2010. إلا أن سي وورلد لم تجرؤ على الإفصاح عمّا حدث وشوهت الحقيقة مُعلنة أن تلك الوفاة كانت مجرد “حادث” نجم عن خطأ برانكو المفُترض عبر السماح لشعرها (ذيل الحصان) بالتدلي في حوض المياه، الأمر الذي دفع الحوت إلى سحبها لأدا عرض ما. وقد اعتُبِر التقرير الذي قدمته المدربة ليندا سيمونز وهو “الحادث” كذبة، فقدت على أثره وظيفتها؛ لإعلانها عن سوء التدريب وخطورة الحيوانات في سي وورلد.
ولكن الأمر استغرق عدة سنوات من تقديم الاعترافات الشخصية في بلاكفيش لوضع الأمور في نصابها (وقد دحضت الحديقة المائية علنًا بعض المعلومات في الفيلم، لذا يبقى الجدل قائمًا). إلا أن الفيلم جاء كاشفًا عن الصمت الذي فرضه المدربون على أنفسهم، والذين شعروا بالولاء نحو الحيتان وأرادوا حمايتهم. بالطبع لم يُقر العديد منهم في البداية ببساطة أنهم كانوا يعتدون على الحيتان ويمارسون العنف ضدهم أثناء تدريبهم وأدائهم معهم. وفي الفيلم، تظهر عيونهم المتلألئة بدموع الندم والأسف بعد اعترافهم لما ارتكبوه من جرم في حق الحيتان، ومن الواضح أن تلك الاعترافات قد جاءت في وقتها تمامًا. كما أفصح المدربون عن غضبهم العارم إزاء أعضاء الإدارة اللذين ظللوا على موقفهم ومتمسكين بكذبتهم الواهية حتى بعد اعتراف جميع المدربين تقريبًا بالحالة الحقيقية لميلاد الحيتان ونشأتها وتدريبها في الأسر أي صهاريج المياه.
وفي تحول نهائي موازٍ لقصة البحار، تحولت سي وورلد نفسها إلى حامية ومحافظة على جميع الحيوانات البحرية. وقد أعلنت هذه السنة أنها ستلغي جميع عروض أوركا على مدار السنوات القليلة القادمة، كما أن الحيوانات لن تُربى بعد ذلك في الأسر. علاوة على ذلك، وجنبًا إلى جنب مع إحدى جمعيات الولايات المتحدة الإنسانية، تتعهد سي وورلد “بالمشاركة بنشاط في الجهود المبذولة لمكافحة القتل التجاري للحيتان، والفقمات، وغيرهم من الثدييات البحرية، وكذلك إنهاء “قطع زعانف أسماك القرش”. كما تعهدت “بحماية الشعاب المرجانية والأنواع البحرية التي تعيش فيها …”. وللحق أنه إذا التزمت سي وورلد بما أخذت على نفسها من تعهدات، ستختلف الحكاية التي سيكون عليها سردها؛ حيث أنه بقيامها ذلك ستمثل صوتًا عامًا لمخلوقات المحيط بأسره؛ الكبير منها والصغير.
اعترافات وسائل التواصل الاجتماعية
لا ريب أن وسائل التواصل الاجتماعية باتت أحدث منصات سرد القصص لإلهام العمل البيئي عبر الاعترافات الشخصية وربما ستظل كذلك في المستقبل أيضًا. وهاكم الأسباب: فالأول بفضل جماهيرها العريضة. حيث أنه بحسب دراسة استقصائية أجراها مركز أبحاث بيو، في كانون الثاني / يناير 2014، فإن 74 في المائة من مستخدمي الإنترنت البالغين في أمريكا يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعية. كما تتمتع وسائل التواصل الاجتماعية بسجل حافل لدعم العديد من القضايا؛ ابتداءً من القضايا السياسية وحتى الشخصية. والأهم من ذلك أن وسائل التواصل الاجتماعية لها تاريخ طويل في تشجيع الاعترافات العامة. فترى موقع تومبلر يتمتع بخاصية وجود “بطاقات اعتراف بريدية” والتي يمكن استخدامها في الاعترافات البيئية. وقد أنشأ مستخدمي الفيسبوك العديد من صفحات الاعتراف، ولكن غالبًا ما تنطوي هذه الاعترافات على الاستخدامات الاجتماعية، مثل الاعتراف بحبيب سري، إلا أنه يمكن إنشاء صفحات مماثلة لنشر مجموعات من الانتهاكات البيئية ونتائجها.
يمكننا أيضا كتابة تدوينات حول ما قمنا به من أخطاء تجاه البيئة. وهاكم المدونة التي أنشأتها بنفسي إكو-كونفيشيونس (http://ecoconfessions.blogspot.com/) أدعو فيها جميع المعنيين بهذا الموضوع إلى مشاركة قصصهم حول الانتهاكات البيئية وما أدركتموه بعدها. وستجدون اعترافي هو المنشور الاستهلالي:
بينما أتجول مع رفاقي ذات يوم في طفولتي عبر أيكة نيو جيرسي المتاخمة للضاحية المتواضعة حيث أقطن. ففي الباقي من غاباتها ومستنقعاتها وجداول مياهها تعيش مغامرات لا تنتهي. راح بعض الفتية الأكبر سنًا يصطادون وينصبون الأشراك ويصيدون الحيوانات، أما عني ورفاقي، فقد قمنا بجولة استكشافية للمكان كما يفعل “علماء الطبيعة” وهم ليسوا في وعيهم. وأثناء ذلك، جمعنا بعض العينات في مرطبانات وصناديق وحقائب واصطحبناها معنا للمنزل. كما استمتعنا بقضاء بعض الوقت نمارس هوايتنا المفضلة وهي إلقاء الحجارة على العديد من الأشياء. وأثناء خوضنا في لعبنا هذا، ألقيت بحجر كبير على أحد طيور الزرنيق زرقاء اللون، فسقط مُربعًا على ظهره فمددته أفقيًا وقتلته. لم يبتهج أيًا منّا لرؤية هذا، فقد كان ذلك تجاوزًا شائنًا وتحذيرًا بشأن الملاحقات المُهملة.
ثم شرعنا في بناء عدد من المصايد القوية مستخدمين طبقات رقيقة من الخشب، وبعض الرباطات المطاطية والعصابات ونحاس بي بي إس للذخيرة. كنت لأستطع ملاحقة الطيور حينها، أو اختراق صدفات السلاحف التي تستمتع بالشمس في البرك بسهولة، إلا أنني لم أفعل ذلك. فقد كبحت ذكرى طائر الزرنيق الأزرق جماح حماستي ورغبتي الشديدة في التهور بقتل الحيوانات. وبهذا أكون قد تحولت أنا الآخر وازداد وعيي حول احترام كل شيء صغير كان أم كبيرًا نتيجة ذلك الفعل العدواني المُبكر الذي ارتكبته والذي شعرت حياله بالأسف لاحقًا. وبفضله قد أكون اختصاصيًا بيئيًا.
نهج البحّار
نحن، مثل كولريدج، بحاجة إلى العثور على صوت اعترافي ومشاركته في أي من الوسائل المتاحة بسهولة، حتى ولو اقتضى الأمر إجراء محادثة وجهًا لوجه – أو نظم قصيدة.
إذ كان قائد قارب الصيد السابق الذي كان نفسه يقود قارب رحلتي إلى جزر القناة حريص على توعية الزوار بأهمية حماية الحيوانات التي كان في السابق يفرط في صيدها. معللًا ذلك بقوله:”أنني – بطريقة ما – أحاول تعويض الطبيعة عن كل ما أُخِذ منها وأُهدِر”. “إذا تسنى لي توعية الناس وتعليمهم – أثناء رحلة الذهاب والعودة – عن مدى الحاجة لدعم هذه المصايد من خلال الحرص على استخدام كل ما قد يصيدوه وإلا يدعوهم وحدهم، لربما بهذا أكون قد عوضتها قليلًا عمّا تسببت فيه من هلاك”. ولكن عندما سألته عمّا إذا كان يشارك قصته تلك مع الزوار، أجاب: “بالنفي معللًا أنهم لم يأتوا هنا لذلك”.
وفي الختام أذكركم أن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بيئية أمر عاجل وملحّ جدًا بالنسبة لنا لدرجة أنه ليس بوسعنا الانتظار أكثر من ذلك ليأتينا أحد المستمعين مقرًا بذنبه. فتلك القصص هي الحلقة المفقودة في تجاهل المجتمع لتحليلات وتحذيرات العلماء والأخلاقيين، وذوي النزعة الإنسانية على حد سواء حول هوس استخدام مبيدات الأحياء. فلو أمكن لجميعنا التواصل عبر أي منصة مناسبة ومشاركة قصننا، لكنا تعلمنا من بعضنا بعضًا، وكنا لنكون على أعتاب عصر جديد من الوعي البيئي والالتزام به والعمل نحو تحقيقه. فقصة البحار مثال لنا على كيفية الانتقال من صفوف المنتهكين للطبيعة إلى المسؤلية الشخصية والمناقشة العامة. وتلك لابد أن تكون قصتنا كذلك.
للاطلاع على المقال الأصلي: هنا
 Iraqi Translation Project لأن عقوداً من الظلام الفكري لا تنتهي إلا بمعرفة الأخر الناح..لابد من الترجمة
Iraqi Translation Project لأن عقوداً من الظلام الفكري لا تنتهي إلا بمعرفة الأخر الناح..لابد من الترجمة